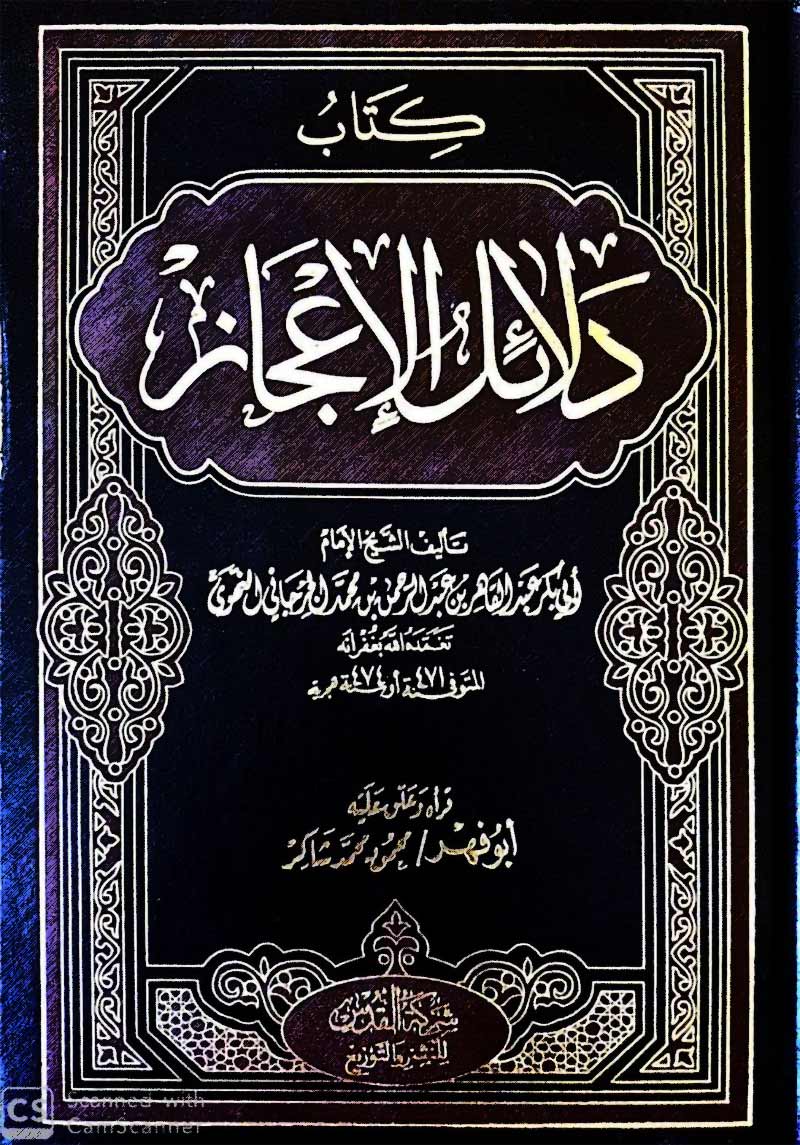معضلة صناعة المحتوى الإسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي
على الرغم من كثرة انتشار قنوات الفِكر والدعوة والتعليم الديني على الإنترنت، إلا أن صانعي ذلك المحتوى يعانون من تحديات شتى لا يعلمها إلا من له سابقة خبرة في ذلك، وهذه التحديات تتنوع بحسب المشكلات التي يتعرض لها صانعو المحتوى الإسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبدأ أحدهم في تقديم محتوى معيّنٍ، نظرًا لوجود تخصّص علميٍّ أو ثقافةٍ واسعة فيما يقدّم، وهو لا ينوي إلا خيرًا، ثم يُفاجأ أن اسمه قد سُحِب إلى صراعات وعداوات لا قِبَل له بِها، ولا مطمح له في خوضها! فبِمَ التَعلُل؟ وما الِعلَّة؟ وكيف الخَلاص!؟
طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي
على الرغم من سهولة وكثرة انتشار المحتوى الثقافي أو التعليمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه المواقع هي مواقع ترفيهية في الأساس، والملاحَظ أن انتشار المحتوى التعليمي المُزخرَف بشيء من الترفيه عبر حيل المونتاج وخِفة مقدم المحتوى إنما تأتي لتتماشى مع الذوق الترفيهي العام، كما هو الحال فيما يُسمى بـ”برامج تبسيط العلوم“.
بناءً على ذلك يمكن القول: ثمة وجود واضح للمحتوى الديني على مواقع التواصل، إلا أننا ننصدم بكون كثيرٍ من جوانب هذا المحتوى تصادميّة وجَدليّة، تحمل في مجملها شعارات (الرد) على فلان و(تبيين حقيقة) فلان والدعوة لمناظرة فلان وفلان، و(مباهلة) فلان.
وللأسف، فإن طبيعة مثل هذا المحتوى تتماشى تمامًا مع طبيعة مواقع التواصل، فهو في حقيقته محتوى ترفيهي لا يبني علمًا ولا يوقّر دعوة؛ حيث إنه يداعب مشاعر الانتصار للذات وشهوة التكبر عند الجمهور المُشاهد، وذلك في حد ذاته مندرج تحت أبواب واسعة من أهداف الترفيه، فهو أشبه بمشاهدة مباريات كرة القدم التي يهتز فيها الجمهور فرحًا عندما يفوز فريقه!

أما طبيعة الإسلام ذاته، فهو دين يحث على العمل النافع ويذم اللغو الفارغ عمًلا بقول الله تعالى: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحًا} [الكهف: 110]، ويحث على العمل الجماعي لا الفردي في الأساس، كما في قول رسول الله: (عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمُ الجَمَاعَةَ) [أخرجه الترمذي في سننه]، ويحث على الجد وترك الهزل، كما في قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اعملوا، فكل ميسر لما خلق له)، وقول الله جل وعلا: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُون} [التوبة: 105].
وليس غريبًا أن الإسلام جعل من مقاصده الاجتماع على الخير ونبذ الفرقة كيفما أمكن، فقد أمر الله تبارك وتعالى هذه الأمة بالاجتماع والائتلاف ووحدة الكلمة ورص الصفوف ونبذ التنازع والتفرق والاختلاف وترك الشقاق والتفرق والتحزب، كما أوضح في قوله: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [آل عمران: 103].
كل ما سبق من طبيعة الإسلام، يُخالف طبيعة مواقع التواصل التي تقتات على الترفيه والهزل والفُرقة والجدال والصراع؛ وبناءً عليه، فإن طبيعة تعاليم الدين ومقاصده الكلية تتناقض مع طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي ومقاصد إنشائها، ومن ثمّ فإنه قلّما اشتُهِر أحد من صناع المحتوى الإسلامي إلا وكان له حيداتٌ عن الطريق القويم الذي رسمه الإسلام في خوض واضح بما دأبت عليه مواقع التواصل من التنازع والسعي للشهرة وتحشيد الجماهير بما يحفّزهم تجاه الآخرين ولو بالكذب!
ما يطلبه المستمعون!
لعلكم سمعتم بالبرامج الإذاعية والتفازية التي اشتهرت بتوفير ما يطلبه المشاهدون والمستمعون من أغانٍ ومقاطع علمية وغيرها من الطلبات التي تندرج تحت هذا النمط.. إننا لو أردنا الآن إسقاط هذه الظاهرة من البرامج على واقع وسائل التواصل، فسنجد التطابق والتوافق كبيرًا.
عادة ما يبتعد المستمعون عن طلب المحتوى التعليمي الجاد الذي قد يستلزم متابعة محاضرات طويلة في سلاسل منظمة تأخذ من أعمار مشاهديها أسابيع أو شهورًا طويلة، ولذا نرى معظم هؤلاء المستمعين يميلون لطلب ذلك المحتوى الذي يُشعرهم بالانتصارات الوهمية الزائفة كطلب أغنية معينة، أو مقطع مخصص من برنامج شهير في الرسوم المتحركة.
مثل هذا المحتوى نراه لدى صانعي المحتوى الذين يبحثون عن عناوين رنّانة لترويج محتواهم ولو كان ضد التأطير العام للأمر الإلهي، فنراه يتعمد التشهير بأحد الدعاة فيقول: (الرد على فلان) و(تبيين حقيقة فلان).. إلخ.
إن الغاية من مثل هكذا محتوى كالغاية نفسها من برامج “ما يطلبه المشاهدون والمستمعون” وهو تغذية مشاعر النصر عند صانع المحتوى ومتابعيه على حدّ سواء؛ في توضيح مباشر لكون جذر أهم الأزمات لدى المسلمين هو التعامل مع الخلافات الفرعية بين المسلمين على أنها شرارة حرب، أو الإصرار في عدم التفريق بين محاربة الفِكر ومحاربة حامِلِيه، وهي أزمة منهجية عميقة في الأساس، تنبني على أساس التوهم بأن الفكر سيسقط بالتشهير بمن يحمله من المفكرين، فيكون الكذب عليهم أو حتى إهانتهم هو من جملة ما يُدافَع به عن الدين!

عدوًا من المجرمين
لم يشهد التاريخ إصلاحًا فكريًا أو ثقافيًا حقيقيًا إلا بمعالجة الجذور، ولا يكون ذلك إلا بالتعليم وبناء العلم بالتدرج عبر منهجية رصينة معتبرة على مدار العصور، فلو كان حامل اعتقاد ما يسعى لنشره ودحض غيره في نفس الوقت –حين الحاجة لذلك– فإن عليه أن يدعم اعتقاده بأدلة وبراهين شتى، وأن يدحض الفكر المخالف بكشف افتقاره إلى الأدلة، وبذلك يقدم أعظم خدمة لما بين يديه من فِكر..
أما عن عداوة صانع المحتوى الإسلامي المعاصرة، فإن المضحك المبكي هو أن العدو الأول سيكون من صفوف المسلمين! وعليه فإن على كل من تصدر العمل في شؤون الفكر والدعوة الإسلامية أن يتوقع أن اسمه سوف يُجَر في صراعات وعداوات لا محالة، وذلك بسبب طبيعة المواقع التي يُصنف غالب مستخدميها من عُشاق الفتن والانتصارات الوهمية لا من طلبة العلم الجادين.
يجب على من يحمل رسالة أن يبدأ مسيره في البحر هادئًا، ولا يغرنه هدوء بحر مواقع التواصل؛ لأن العاصفة آتية لا محالة، وليس المطلوب من كل ذي رسالة أن يترك ما بدأ انشغالًا بكثرة من سيحاولون سحبه إلى صراعاتهم الضيقة، بل المطلوب هو توقع مجيئهم ومعاداتهم له، ليتصرف معهم على النحو الذيي تقتضيه الحكمة وواقع الحال.
وأهم من ذلك كله، ألّا يكون ظهور الأعداء داعيًا للمحيد عن وِجهة الرحلة، بل على المرء أن يجدد نيته مرة تلو المرة ليكمل المسير في رضا الله وتحقيق الخير والعلم للعباد، وأن يعلم أن التخاصم والتنازع بين الناس من طبيعة الحياة كلها لا طبيعة مواقع التواصل فحسب، وهو ما أوضحه تعالى حين قال: {وكذلك جعلنا لكل نبيًا عدوًا من المجرمين وكفى بربك هاديًا ونصيرًا} [الفرقان: 31].