هل الملحد ملحد حقاً؟
هل يكفي رفع لافتة أو التباهي بشعار ليقطع هذا بالانبثاق عنهما أو الالتزام بمقتضاهما؟ وهل يصح التسليم بصدق الموقف إن أعلن أحدهم أنه يؤمن أو لا يؤمن؟ يتشبّث بعضهم بوصف “الإلحاد”، فيحبسون وعيهم في مقولات منسوجة بعناية خشية أن يتخطوْها إلى آفاق الإيمان. ترتهن النزعة الأيديولوجية في هذا المنحى لمقولات صارمة تفرض سطوتها على العقل والقلب، لكن بأي شيء يؤمن أحدهم في أعماقه إن أعلن أنه “لا يؤمن”؟
عقيدة رفض الاعتقاد
إن بلغ رفضُ الاعتقاد مرتبةً اعتقادية ألا تكون هذه “عقيدة رفض الاعتقاد”، أو ديناً يعلن التبرّؤ من الدين؟ فالذين يتباهون بالتنصل من “الدين”، يتقمصون ملامح اعتقادية يفرّون عبرها من المعتقد إلى المعتقد. وإذ يضيقون ذرعاً بالمقدس فإنهم ضالعون في التقديس، فلا تبقى مساحة المقدس في وعي الإنسان شاغرة بأي حال. إنهم يقدسون قناعات وشعارات، ومقولات وأنظمة، أو يعظمون وجوهاً وأسماء، ولو على طريقة الذين طمسوا الدين من حولهم ثم نحتوا الأصنام بأحجام شتى لماركس وإنجلز ولينين، فنصبوها في الميادين والمكاتب والمنازل، وجعلوا “المانيفستو” كتاباً مقدساً في هيئته وهيْبته وطبعوا منه نسخاً مجهرية لتغدو تعاويذ مثل تذكارات المزارات الدينية.
ولو أزيحت المقدسات جميعاً من الوعي، فقد يكون الإنسان ذاته هو الذي تألّه، مثل إشارة أحدهم التلقائية إلى رأسه كناية عن تعظيم شأنه وتقديس اختياراته. قد نرى في انشغال بعضهم الدائم بوجود الله في مسعى النفي والنقض، كنايةً عن صراع مع إيمان مكبوت في الأعماق، وهو كبت تساهم فيه ثقافة عصر تأخذ بالألباب كل مأخذ وتهيمن على الوعي من حيث لم يحتسب، فيرى الإنسان نفسه في مركز الكون وإن كان لا يُرى بالعين المجردة من رؤوس الجبال. يميل إنسان الحاضر إلى تأكيد ذاته، وتضخيمها، والتعالي بها، وتصويرها ذاتياً على نحو صنمي ونرجسي، حتى يتطلّع بعضهم لأن يشغَل بنفسه موقع الألوهية وإنْ بصفة لا شعورية، فلا يرى شيئاً يعلوه سوى منظومة ضوابط وقوانين وأعراف صاغها البشر أنفسهم وقد لا يترددون في تجاوزها. أي شعور يخامر أحدهم لدى التمرد على مرتبة المخلوق والسعي إلى مناجزة خالقه؟ أليس هو الإنسان ذاته الذي يتضعضع إزاء مديره في العمل، أو يتقلص في حضرة المخالفة المرورية، أو تعلو صرخاته في عيادة الأسنان؟

لا تأتي الحالات على لون واحد، فبعضهم يتخذون الإلحاد سبيلاً لأنّ أسئلة ظلت معلقة في وعيهم بلا إجابات مقنعة. ومأزقهم أنّ اقتناع أحدهم من عدمه لا يقضي دوماً بالصحة أو البطلان، فالاقتناع لا يحصل من الناس جميعاً بالمقولة الواحدة على منسوب محدد أو بكيفية واحدة. وقد يحصل الاقتناع بما هو هش أساساً أو متناقض للغاية، وهذا ضمن ملابسات تدفع بوعي زائف. ولا يخضع الاقتناع للعقل “المحض” وحده، بل هي حالة يتفاعل إنتاجها مع الوجدان، فملابسات الواقع والشحنات المعنوية والمؤثرات المصاحبة، وبعضها غير ملحوظ أساساً، تغري بالاقتناع بخيارات لا مصلحة فيها. ولا يندر أن يقتنع البشر بالشيء ونقيضه، وفقاً لمُدرَكات ومؤثرات ومشارب وأفكار مسبقة وتحولات نفسية واجتماعية وثقافية متضافرة، فكيف إن اتسمت المرحلة الراهنة بتحولات متسارعة وهزات جسيمة وأزمات طاحنة وتضعضع البنى القيمية التقليدية؟ إنّ العقل الذي يحتج به أحدهم، هو ذاته الذي يتفنن خبراء التسويق والترويج والدعاية و”حرب الأفكار” في استمالته وإخضاعه والهيمنة عليه، لدفعه إلى قناعات واهية وشراء ما لا يحتاج وانتخاب الفاسدين. وإن “قرر” بعضهم العدول عن الإيمان لأنّ أسئلة بقيت عالقة في وعيهم، فهل سيعني هذا أنّ اختيارهم النقيض يجيب على الأسئلة جميعاً بصفة متماسكة ومتسقة؟ ألا يمكن افتراض أنّ منطق “عجز النقيض” الذي يبرر به بعضهم الإلحادَ، من شأنه تسويغ الإيمان بالأحرى. فهل الإلحاد قادر أساساً على تقديم رؤية كونية شاملة ومتماسكة ذات قدرة تفسيرية سابغة حقاً؟ وهل يفسر الإلحاد لصاحبه الوجودَ بما يحتويه، تفسيراً منسجماً ومتماسكاً، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟
يستبطن الإلحاد روحاً عدمية، تصرّ على نفي ما فوقها وما وراءها وما يعقبها، ومن تفاصيلها مثلاً أنها تنفي النبوات وتقدح بالرسالات، وتحطِّم تاريخ المؤمنين وتنزع عنه الشرعية وتُنكر مغزاه الرسالي وجدواه القيمية، ولا يغدو ذلك كله، إن تم الاعتراف به أساساً، سوى تروس في حركة تاريخ يفقد معناه ودورات في عجلة زمن يؤول من عدمية إلى عدمية، وعناصر عابرة في تدافع بشر لا ينتظرهم حساب على ما قدموا. تفرض رؤى الإلحاد على الإنسان تعبئة فراغ كبير أحدثته، كي يتملّص من عدميتها، وقد يمضي بمعتقده “الجديد” هذا إلى التألّه إن فعل، عبر تقديس ذاته وتمجيد عقله وتعظيم انفعالاته، ومن المألوف أن يمنح هذه الحظوة لمن يعدّهم دون غيرهم طلائع الفكر وفلاسفةَ البشر ورواد التاريخ.
يتجلى تأليه الذات في تعبيرات فجة جاء بمثلها أحدهم في برنامج عربي للفرجة بقوله “هنا الله”، وأشار إلى عقله بعد أن انعطف الحديث إلى الدين. وكيف يَقوى المتسامرون على مناقشة المتحدث الجسور عبر البث المباشر؟ ومن بوسعه مقاومة الاعتداد بالعقل؟ يجوز التساؤل إن كان جليس الشاشة يعني “عقله” الذي يترنح بأثر شراب متخمر، أو تمسك بخطامه شهقة من مسحوق أبيض، ثم يخامره النعاس كل ليلة بما يكبح قدراته التحكمية على الأقل؟

ملحد يكبت إيمانه
يرفع بعضهم لافتة الإلحاد بما يملي عليهم كبت إيمانهم. إنهم يؤمنون في أعماقهم، لكنهم يطمرون إيمانهم ويحجبونه بعيداً كي لا يزعزع موقفاً بات سمة من سمات تصوّرهم لهويتهم الذاتية وحضورهم في الوسط المجتمعي. قد تتهيأ فرصة ما تتحرر فيها روح مؤمنة من قفصها في لحظة وعي داهمة بالحقيقة؛ لحظة تنقشع فيها حُجُب كثيفة تراكمت على الأسماع والأبصار.
يبدو بعض “الملحدين” أوفياء حقاً لإيمان عميق يكبتونه، إن أعادوا النظر في حقائق الوجود المرئية وباشروا تشغيل عقولهم بلا تحفظات، أو تأرجحت بهم طائرة في الأجواء، أو علا بهم الموج في عرض البحر، أو خفقت قلوبهم في انتظار خبر مصيري بين يدي طبيب يعكف على تشخيص حالة مُريبة، أو احتضنوا بين أذرعهم مواليدهم الأوائل الذين هم آية من آيات الله تعالى.
إغراء الهالة المجيدة
ترسم خطابات رائجة، هالةً إيحائية مجيدة حول من يُعلن إنه “ملحد”، وهذا بقصد منها أو بدون قصد. فليس نادراً أن يقع ربط الإلحاد بالاشتغال الفكري والتألق العقلي والتفرد الذاتي والاعتداد بالرأي، وهي سمات محجوبة في هذه الخطابات عن المؤمن والمتدين وقد يُرمَيان بنقيضها.

بات نفر من متحدثي “البرامج الدينية” ينظرون بعين العطف إلى مَن يقولون إنهم “ملحدون”، وليس نادراً أن يصبّ المتحدثون أنفسهم سوط القسوة على “المتدينين” ويُشبعونهم غمزاً ولمزاً بدوافع تبدو للوهلة الأولى إرشادية وإصلاحية. تمنح المفارقة انطباعاً يتضافر عبر مضامين بعض تلك البرامج، بأنّ “الملحد” مثقف رصين ينطلق من نظر عقلي وتقدير قيمي وحس نقدي وموقف عصري، ولدى الحديث عنه بمنطق يبتغي الإقناع والاستمالة؛ يقع التطرق إلى أفكار العالم وأساطين الفلسفة واستعراض العضلات الفكرية، أما “المتدين” فليس نادراً أن يطارده أولئك المتحدثون بلغة إيحائية ذميمة تزدري هيئته وتستقبح مسلكه وتستخف بثقافته وتستهين بتحصيله، ضمن تصورات رائجة تقوم على قوالب نمطية ذميمة وأحكام مسبقة تعميمية، بصرف النظر عن مدى صلتها بالواقع.
ليس بعيداً عن ذلك يأتي خطاب لوبي الإلحاد متقمصاً رداء “العلمية” و”العقلانية”، فيراهن بهذا على غواية الذين تسحرهم مقولات تمجيد الذات واختياراتها وتقديس العقل وتفضيلاته والتملص من معابد الدين إلى معابد العلم. وإن أوحى بعضهم باجتياز “رحلة فكرية معمقة” أوصلته إلى هذا الاختيار؛ فما يَسهُل اكتشافه أحياناً أنّ بعض الرؤوس محشوة بمقولات محبوكة أو شعارات أيديولوجية، تم تجهيزها مسبقاً في “لوبي الإلحاد” وأُعيد إنتاجها وتمريرها بما يتناغم مع نفسية الجماهير في هذه الحقبة. وقد تتكثف التأثيرات على وعي بعض الأفراد بصفة تعبئة أيديولوجية تحاكي في بعض صورها فنون غسيل الأدمغة.
في قراءة الحالة
طورت اتجاهات شتى في فضاءات العالم، بما فيها النزعة الإلحادية، جماعات ضغط وتشكيلات ناشطة تستعمل أساليب متجددة من الكسب والإقناع والاستمالة، وتجد في هذا دعماً سخياً من نزعات سائدة ونفسيات رائجة وأنماط تفكير تتغذى مما يسمى “ثقافة العصر”، كما تجسدها الصناعات الإعلامية والثقافية والفنية.
إنّ نفسية إنسان الحاضر مشحونة أساساً بمقولات الانعتاق ورفض الانصياع ونبذ الهيمنة العلوية أو التوجيه الفوقي، كما أنّ افتتان الفرد في زمن التصوير والتشبيك والبث بقدراته الذاتية على الحضور العام والتأثير والإسماع والإزعاج قد يغريه بالاستنتاج أنه في مركز الحالة وشريك في صناعتها. تضغط هذه التحولات والمتلازمات على وعي أجيال الحاضر بمؤثرات نفسية، بعضها غير ملحوظ أساساً، وبجهود دعائية محبوكة بعناية تفتن إيمانها وتسليمها. وما استجد أيضاً؛ أنّ أصوات المجتمع جميعاً تحوز اليوم فرصة الإسماع وإحداث الضجيج كما لم يحدث من قبل، مهما قلّ المنتسبون إلى كل صوت منها، وبهذا تعيد المجتمعات اكتشاف التفاصيل المتنوعة الكامنة تحت سطحها بعد أن تجاوزت التحولاتُ مركزيةَ التعبير عن المجتمع واحتكار قنواته.
والواقع أنّ حالات الشك والإلحاد بصورتها الفردية أو الجماعية، لم تغب يوماً عن المجتمعات ولو كانت مُسلِمة، حتى تمددت الشيوعية مثلاً في ثنايا عربية في ما مضى، ومعها مذاهب وفلسفات غير متصالحة مع الإيمان، بل شارك وكلاؤها المحليون في الإمساك بزمام الحكم طوعاً أو كرهاً، ومنها عدن، عاصمة الشطر الجنوبي من بلاد الحكمة والإيمان. لكنّ اللافتة الحمراء في التطبيق العربي لم تفرض دوماً التنصل من الدين، بل اشتهر عن قيادة الحزب الشيوعي السوداني ريادة المساجد مثلاً، وقيل في بلاد الشام إنّ الانتماء الأحمر قد لا يتجاوز القشرة بينما يبقى الجوهر على فطرته، وعبّر بعضهم عن ذلك بوصف طريف شاع في النصف الأول من القرن العشرين، هو “شيوعي فجلة”!
على أنّ الإلحاد، في منحى الإفصاح الجديد عن ذاته في المجتمعات العربية والمسلمة، يتناغم مع نزعة تحدي النسق الثقافي المرجعي للمجتمعات. يستقوي المنجرفون مع الحالة بالشبكات الاجتماعية مثلاً وبتطبيقات مدنية تتيح الانتظام وتكثيف الحضور وتضخيم الأثر. ولا يبتعد ذلك في نفسيته وتمظهره عن تجارب أخرى متضافرة، كإعلان التمرد على الشعائر الإسلامية والصدام مع الحس الديني العام، من قبيل جماعة المجاهرة بالفطر في رمضان أو سلوك التعري التنديدي وغيرها، ويوظف المتحدثون والناشطون في الترويج لهذه النزعات تطبيقات صاعدة في المجتمع المدني والفضاء الشبكي حول العالم.
وفي التعبير الراهن عن نزعة الإلحاد إفصاح مهم عن حيرة أجيال عربية ومسلمة مسّها طائف من “ما بعد الحداثة”، التي تفصم العلاقة بين الدال والمدلول، وتمضي بمنحاها النسبي في إسالة المعايير وتقويض القيم والمبادئ من داخلها بما يُفضي إلى عدميتها. تأتي التفاعلات على البنيان الاجتماعي فتنزع الوصف والمعنى حتى عن المفاهيم التأسيسية المتعلقة بالأسرة والزواج والذكورة والأنوثة والأمومة والأبوة، لتصبح هذه جميعاً ألفاظاً غير محددة الفحوى فتحتمل طائفة، لا نهائية تقريباً، من النماذج والحالات في التطبيق الواقعي.
وما ينبغي الإقرار به أنّ مناهج التعليم ومضامين الإرشاد ليست مصممة لاستيعاب متغيرات جارفة، وقد لا تنجح المدرسة بصورتها الراهنة في تمكين الأجيال من الإبحار وسط أمواج متلاطمة، فضلاً عن قدرة المضامين الإعلامية والإرشادية المتاحة على النهوض بالدور وسط انشغالها بأولوية “مكافحة التطرف والإرهاب”. كما تعجز وفرة من الخطابات الرائجة في الفضاء الديني عن استيعاب التفاعلات الجارية في مجتمعات الحاضر، ومنها ما يتلبس الظاهرة الكبرى المسماة بالعولمة من تداعيات عميقة تداهم الأمم من حيث لم تحتسب.

تبرير الإلحاد بالسلوك
يتذرّع بعضهم بأسماء ساطعة من الماضي والحاضر اختارت الإلحاد لما عايشته في محيطها من استعمال مُسيء للدين. وما يتم تقديمه، عادة، بمثابة سبب أحادي ساذج لإلحاد شخص ما، يبقى جديراً بالبحث والفحص. فمن المألوف أن يميل الإنسان إلى تأويل بواعث اختياراته وسلوكه بعلة فريدة لا تبديل لها، مع استبعاد تضافر أسباب أخرى محتملة خلف الحالة، لكنّ تشخيص السبب أو الأسباب ليست مهمة سهلة كما لا يُقطَع بصحة التأويل الذي يأتي من صاحب الموقف ذاته أو ممن يعرفونه، بل قد يكون الإتيان بها من صاحب الموقف أو مَن شايعوه سردية تبريرية لمسلكه.
أما تأويل الإلحاد بسلوك مشين محسوب على “أهل الإيمان”، فيفرض استدعاء المنطق ذاته في الاتجاه العكسي، أي إمكان تأويل الإيمان ذاته بسلوك ذميم محسوب على “أهل الإلحاد”، وشواهده لا تنقطع كما في مجزرة الكنيسة في تكساس (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017). غاية القول في هذا الشأن أنّ المنزع الانتقائي للبواعث يُظهِر هشاشة منطقها، فانتقاء حالة أو حالات مخصوصة لا ينفي ما سواها أساساً ولا يجعلها سابغة أو ممثلة شرعية للواقع ككل.
ثم تصرّ بعض الخطابات على تبرير نزعة الإلحاد بحالات التشدد والتوحش المتذرعة بالدين أو تسويغها بما يقع من وجوه الحالة الدينية ومتصدريها. تبدو هذه اندفاعة متوقعة تحت سطوة الاستعمال الديني المُسيء، الذي يبقى قائماً في كل زمن ومجتمع، لكنها تعزز الاستنتاج بأنّ هذا “الإلحاد” المُعلن إنما هو موقف نفسي ووجداني في الأساس وليس فكرياً وعقلانياً بالأحرى. تتجاهل هذه الذرائع، مثلاً، أنّ معظم المسلمين المتدينين ينبذون “داعش” مثلاً، علاوة على أنهم أبرز ضحاياها، كما أنّ جماعات التشدد الديني من طوائف شتى لا تحظى بغطاء الأغلبية المتدينة منها غالباً.
ثم، ألا يستدعي الرضوخ لهذا المنطق تشديدَ النكير على “الحرية” لمجرد أنّ الثنائي الماكر بوش وبلير أحرق العالم الإسلامي بحروب استعملت هذه القيمة المجيدة ذريعة لخوضها؟ وما الذي سيبقى من قيم أساسية سامية ومقولات جوهرية نبيلة في عالمنا، إن تمت الإطاحة بها بذريعة سوء الاستعمال الذي مورس بحقها جميعاً بلا هوادة، ومنها قيم الثورة الفرنسية مثلاً التي تم استعمالها غطاء لفظائع الاستعمار؟
إنّ السلوك الاستعمالي لدين أو لقيمة أو لفكرة لا يصحّ حُكماً عليها، وإن أظهر التسليمُ بهذا الباعث أنّ النزعة الإلحادية المعنية تشكّلت أساساً من موقف نفسي أو نفور جامح أو عقدة ما مترتبة إزاء حالة أو شخص أو سلوك، ثم مضت تالياً إلى شرعنة ذاتها بمقولات عقائدية تبريرية لها. وقد لا يكون هذا الموقف سوى حدث رمزي أو نفسي أو قشة قصمت ظهر صاحبها بعد تراكمات حملها أحدهم في عقله ووجدانه؛ دفعته إلى تأويلات داخلية مخصوصة وأحكام صارمة وتبريرها بمنطق قطعي تبسيطي عبر ربط القناعة المعلنة بحدث ظاهر لا مراء فيه، من قبيل فظائع “داعش” أو شطط بعض متصدري المنابر الدينية.
وأيا كانت البواعث، فلا غنى عن الترفق في وصف مقامات الفعل الذهني والشعوري الذي يخامر الأفراد في زمن الاضطراب والتشنج والصدمات، الذي تجزع فيه الأنفس وتطيش فيه العقول، والحذر واجب من دمغ الحائرين في موسم مخصوص بوصمة المروق من الدين، علاوة على مشروعية التشكك بعمق الالتزام بمقولة الإلحاد، التي يتباهى بها بعض الذين يكبتون إيمانهم.

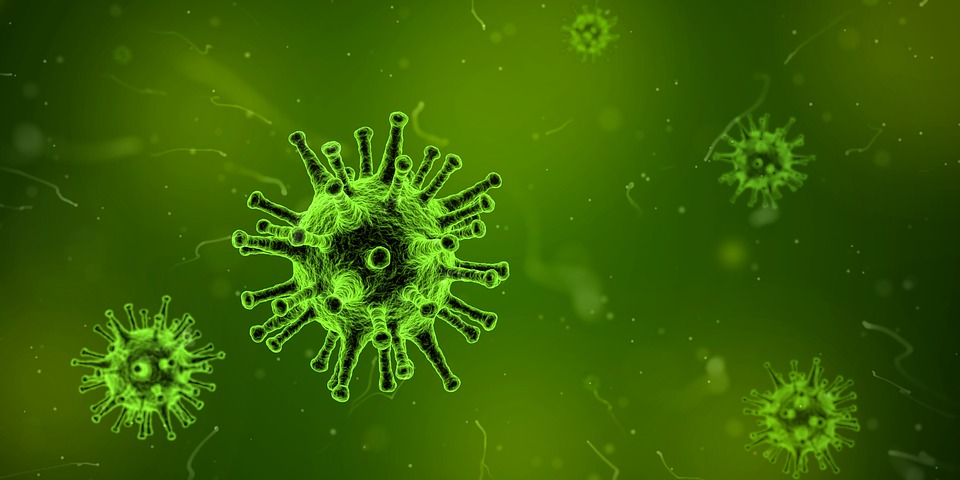


 السياقات اللوثرية ومآلاتها
السياقات اللوثرية ومآلاتها